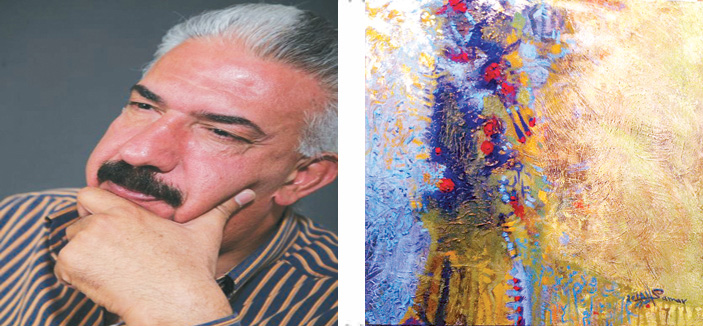أزمة الثقافة العربية
تُعتَبَر القضيّة الفلسطينيّة واحدةً من أهمّ القضايا التي دار حولها الأدب العربي، وعالجها منذ عشرينيّات القرن الماضي وحتى الآن. لقد شدّت هذه القضيّة بما تُمثّله من أبعاد تراجيديّة ونفسيّة عميقة أفئدة الشعراء والرّوائيّين العرب، ودخلت في العَصَب النّابض للكتابة، غير أنّ هذه القضيّة وعلى الرّغم من الإبداع الكثير الذي كانت سبباً في إنجازه، ظلّت عصيّةً على سبر الأغوار، فقد علا الدّم أسوار الشّعر، كما فاض الألم عن إناء الحكاية. لقد مرّت هذه القضيّة بمجموعة من الانعطافات الحادّة، فتعملقت وتلوّنت بالفجائعيّ والغرائبي، في الوقت الذي ظلّت فيه الكتابة بمثابة تابع صغير لها.. بمعنى آخر لقد عجزت الكتابة باستثناءات قليلة في الشّعر وقليلة جدّاً في مجال الرواية عن تمثّل الطّقس القيامي الذي تشهده هذه القضية، وتحويله لصالح الإبداع.
أين الكتابة العربية من النّكبة التي وقعت في العام 1948، حين ضاعت فلسطين أوّل مرّة، وتصدّع التّاريخ العربي المعاصر؟.. أين تلك الكتابة من هزيمة حزيران عام 1967، التي لا نزال نشهد آثارها المدمِّرة حتى هذه اللحظة؟ أين تلك الكتابة أيضاً من احتلال بيروت عاصمة الثورة والثقافة العربية عام 1982، ومن مجازر صبرا وشاتيلاَ التي تلته ولطّخت بالعار جبين الإنسانية؟.. ماذا فعلت تلك الكتابة إزاء الانتفاضتين العظيمتين الأولى والثانية؟.. ماذا فعلت عندما تمّ احتلال بغداد وتدمير العراق؟.. أخيراً ماذا أنجزت تلك الكتابة من نصوص، وما هي المواقف التي تمثّلتها في زمن الثورات العربية المغدورة، حيث يسير العالم العربي القهقرى بفضل هذه الثورات، ويتم فيه القضاء على كل حلم!!!
للإجابة على تلك الأسئلة يمكن القول إنّ الكتابة العربية لم تتمثّل جوهر هذه الأحداث الكبيرة، بقدر ما كانت تسعى إلى ملامسة سطحها الخارجي.. لقد تعاملت مع هذه الأحداث من موقع الفرع الذي يطمح إلى اللحاق بالأصل، ومن موقع الطّارئ الذي يطمح إلى تقليد الثابت المتجذّر. لم تحاول هذه الكتابة أن تكون بمستوى هذه الأحداث، وبالتّالي أن تُقدّم مساهماتها الكبيرة على طريق إعادة صياغة الوجدان العام، وتشكيل حالة عضوية تُمكّن الأمّة من الصّمود والمواجهة. ثمّة يافطة ضخمة نرفعها باستمرار كلّما تعرّضنا لصفعة جديدة: الثقافة هي حصننا الأخير، أو الخندق الأخير للأمّة!! كأنّنا نتناسى عمداً وعن سبق إصرار الإهانات الحضارية التي نتعرّض لها من وقت إلى آخر، وأقدام الأعداء التي لم تترك قدس أقداس لنا إلاّ وداسته بالبساطير الثّقيلة! على العكس من ذلك أنا أرى أنّ تلك النّظرة التي تحكم الثقافة، وبالتالي رؤيتنا لدورها وفعاليّتها هي نظرة طوباوية بامتياز، ذلك لأنّ الثقافة لم تكن في أيّ يوم من الأيّام مجرّد كتلة مقذوفة في الفراغ، ومفصولة عن الواقع الموضوعي الذي تتحرّك فيه. الذي جرى أنّ الأعداء ومنذ اليوم الأوّل استهدفوا الثقافة القوميّة، وعملوا على شرذمتها وتفتيتها. بخلاف ما يُشاع فقد دخل الأعداء من خندق الثقافة المتداعي وأسقطوا قلاعنا واحدة تلو الأخرى.
بعد حقبة الاستقلال الوطني، وبدل أن نحاول ترتيب بيت الثقافة القومية، سقطنا في فخاخ القطرية.. وتحوّل الوطن العربي بفعلها ليس فقط إلى دويلات بحدود وأعلام، ولكن إلى مجرّة من الكيانات والإثنيّات الصغيرة المتناحرة.. دون حروب ارتفع علم الكيان.. وصار المطلوب منّا مصافحة يد المجرم التي تقطر بدماء أطفالنا.. سنوات وداهمتنا العولمة فطرنا كورق الخريف اليابس في المهبّ، وصار من السّهل العبث بمصيرنا وترتيب مستقبلنا القادم.
على صعيد الخاسرين في هذا الواقع المتردّي الذي يشبه السّيرك المفتوح، كانت الثقافة بمعناها العضوي هي الخاسر الرّئيس، بالإضافة إلى تمثّلاتها الإبداعية في الأدب، إذ إنّها سرعان ما تنحّت جانباً لصالح أشكال أخرى هجينة ظهرت على حين غِرّة وتصدّرت المشهد.. لقد برز الإعلان كواحد من أهمّ الأشكال (الإبداعيّة) الجديدة التي لم تقف عند حدود التّرويج للسّلعة بل امتدّت مهمّتها إلى تحطيم المُثل الثقافية السّائدة والسّخرية منها.. الأغنية هي الأخرى صعدت إلى الواجهة كشكل (إبداعي) جديد اعتمد في الوصول إلى الجمهور مثله مثل الإعلان على مجموعة من التّقنيات.. إنّها أعمال (فنّية) مركّبة، كما أنّها لا تحتاج إلى كبير عناء من أجل الوصول إلى المشاهد من أوسع الأبواب.. إنّهما الإعلان والأغنية جزء من حملة شعواء يجري من خلالها ضرب الثقافة القومية والإطاحة بها.. ما العبرة مثلاً وراء كلّ هذا الحشد الهائل من المطربين والعازفين الذين يهتفون للحبّ التّافه الممسوخ، وللأحلام الفارغة، سوى توسيخ أرواحنا والرّكض بها حتى حافة السّراب!
مقابل هذه الأوضاع المتردية لم تنشأ هناك في الجانب الثقافي حالات حقيقية من المجابهة والتّصدّي.. جزء من المثقفين انسحب من الحياة العامّة، وأحاط نفسه بسياج من العزلة.. وبسبب ذلك فقد انسحبت الثقافة التي ينتجها إلى أجواء كاسحة من الاغتراب. الجزء الثاني أخذ على عاتقه القيام بدور المدافع عن المشروع الثقافي العربي وحمايته من الاختراقات التّطبيعيّة، غير أنّ هذا الجزء توقّف عند حدود الشّعار، ولم يقُم بتحديث أدواته، فظلّ يستخدم الأدوات القديمة إيّاها، ويدور في حلقة مفرَغة. كان من الممكن لهذا الاتّجاه أن يُواكب العصر ولكنّه لم يفعل، ونتيجةً لذلك فقد أوصل الاتّجاهان السّابقان الثقافة إلى الطريق المسدود، وحالا دون انخراطها في معركة الحياة.
في هذا السّياق لا بدّ من التّطرّق إلى بعض العوامل الحاسمة التي أفرغت الثقافة العربية من مضمونها، وعلى رأس هذه العوامل الغياب المدوّي للديمقراطية في البلدان العربية، وقمع المثقّف وتدجينه، وبالتّالي مصادرة دوره، وإلغاء أيّ إمكانية أمامه يمكن أن يفيد بها الوطن. لم تنضج لدينا الظّروف بعد لنعرف أنّ الركن الرّئيس من مهمّة المثقّف يتمثّل في النّقد، وفي إعطائه الفرصة ليقول كلمته مهما كانت صادمةً وجارحة.
في الألفية الثالثة يقف المثقّفون العرب بكامل حيرتهم، و»ظهورهم إلى الحائط السّاقط»، كما يقول الشاعر محمود درويش، وبذلك فمن الصّعب عليهم القيام بالمهمّة الموكولة إليهم، ولن ينجزوا شيئاً ذا بال على صعيد المحطّات المركزية التي يمرّ بها التاريخ العربي، فصنع الثقافة هي مهمّة تتكفّل بها الجماعة في الدّرجة الأولى.