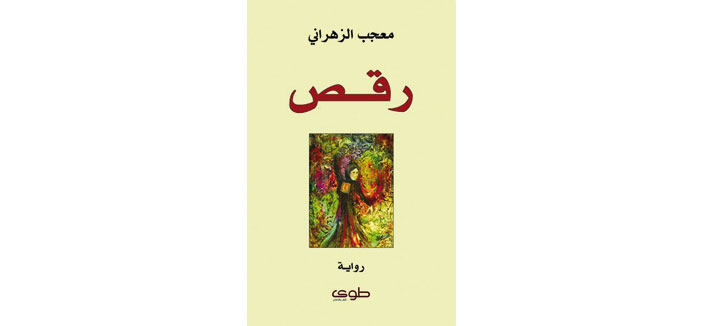(أبواب الأسى .. وشبابيك الحنين) (2-4)
السيري الذاتي و التخييّل الروائي
عدا الفنون الشعبية، والنتاجات المشتركة، يمكننا القول بأن العمل الإبداعي غالباً ما ينهل من منابع حاضنته الذاتية، باعتباره – رغم تعالقات الذات بالجماعة - نتاج ذات و صنيع فرد واحد، لذلك لا يمكن أن يخلو نص إبداعي من تماس سيرة الذات أو تداخلها، في أبعادها الحياتية والثقافية والسيكولوجية، مع نسيج ذلك النتاج وتشكّلاته، وقد عبّر عن ذلك الروائي الأرجنتيني «ارنستو ساباتو» بقوله « إن أي عمل أدبي أو فني هو سيرة ذاتية، بمعنى ما».
وإذا كان الشعر قد حسم منذ البدء وشرعن، بحكم غنائيته، بتلازم النص بفردية الشاعر و سيرته الكلية، فإن الرواية، باعتبارها عملاً تخييلياً موازياً للحياة، قد استثارت الكثير من الجدل التنظيري حول ما يمكن اعتباره سيرة ذاتية أو رواية تاريخية، أو ما يمكن وصفه بالسرد التخييلي الخالص الذي ينتمي لنوع الكتابة الروايئية.
يقول الناقد والروائي د.معجب الزهراني في كتابه « مقاربات حوارية « في بحثه حول «رواية السيرة الذاتية» ما يلي: « نزعم ان الحافز العميق لكتابة الذات عن ذاتها يتحدد أساساً برغبة الفرد الكاتب في الاعلان عن حضوره كشخصيةٍ إنسانية مبدعة مستقلة لديها ما تريد التعبير عنه و تبليغه للآخرين.. ومن المنظور الفكري العام نحسب أن كتابةً كهذه تشخّص أكثر من غيرها أشكال الوعي بعلاقات التوتر بين الفرد الحديث والسلطات السائدة في مجتمعه، وهو وعي شقي يُكتسب في مرحلة متقدمة من العمر ...» (ص 95)
لكل ذلك تضعنا رواية «رقص» في سياق ذلك التوتر (بين الفرد و السلطات المهيمنة)، لأن خطاطتها السردية الرئيسة تنبني على فاعلية السارد (الذي ينوب عن الروائي) كبطلٍ ثانٍ لهذا العمل، يتحدث فيه عن لحظة مغادرته الوطن كمهاجر، ضاق به قلب الوطن، ليذهب باحثاً عن فضاء حرِ يمنحه القدرة على التأمل و الشجاعة في اشتغاله على إعادة كتابة سيرة المكان (القرية- الوطن)، والإنسان متمثلاً في حياة الناس البسيطة، التي وئدت في القرى، و في الأحلام المقموعة لبطلي النص ( السارد وسعيد).
و في هذه الكتابة التي ينبني فضاؤها السردي ( مكاناً و زماناً و شخصيات ) على فاعلية استعادة ما لا يبقى إلا في الكتابة، تنحلُّ كل الأشياء والأسماء والأمكنة والأفكار والرغبات والآمال، لا لتتخلّق كنصٍ موازٍ للواقع وحسب، و إنما لتصبح بديلاً عن ذلك الواقع، سيما وأن السارد قد أعلن في بداية نصه عن هجرته النهائية من « الوطن»! و في باريس تتوهج فتنة الرقص التي شغلت حيزها الحي والدال طويلاً في ذاكرة الروائي- السارد، فتلد لحظة الكتابة عن رقصة الأهالي الذين احتفلوا في قرية جنوبية بخروج إبنهم من السجن، بعد سبع سنوات قاسية. وينفتح فضاء السرد هنا على استعادة حوار مطوّل جرى قبل خمسة و عشرين عاماً بين بطلي النص، في مدينة « رويان» الفرنسية، ليتعرف فيه ( الروائي -السارد) على تفاصيل التجربة، ومراجعاتها، و سياقاتها اللاحقة و المغايرة تماماً لسيرة « سعيد» النضالية، و ليكشف السارد عن احتفاظ بطل النص، رغم كل ذلك، برؤيته النقدية للتجربة وللحياة الاجتماعية والسياسية على أرض الوطن.
وفي تفاصيل ذلك الحوار الطويل تتبدى نزعتهما» النستالوجية» المشتركة لإعادة تشكيل روح حياة كانت تتسم بالعفوية في القرى الجنوبية، تجلّت في الأعراف الإنسانية التي تحترم مكانة المرأة كشريك في الحياة، و في الفهم الصادق و الفطري البسيط للدين، وفي الانفتاح على الآخرين، لتكون بحقيقتها (المدونة في النص) أكثر انتماءً لفضاء الحرية الطبيعية المحايثة لحياة البشر في كل مكان، قبل أن يتم قمعها واختطافها منذ زمن بعيد، من قبل تكوينات اجتماعية - سياسية وعقدية متعاضدة، عملت بوعي أو بدونه على تغريب الإنسان عن ممكنات حياته و وجوده التي عاشها منذ مئات السنين.
و بإزاء الفقد الفادح لتلك الروح، تبرز آليات الحنين لمباهج الجمال والمعاناة والتحدي في سيرة المعارض السياسي السابق «سعيد»، حيث يأتي إلى باريس للبحث عن حبيبته التي فقدها قبل دخوله السجن في عام 1969م، و للتنقيب أيضاً عن سيرةٍ مفقودة لشخصٍ آخر، هو «راشد الزهراني»، الذي يرمز هروبه الى إسبانيا و فرنسا عن معارضته المبكرة!
و هنا يندمج بطلا النص معاً في فضاء البحث عن السير الذاتية: السارد يعمل على تدوين سيرة «سعيد»، و سعيد يسعى إلى تدوين سيرة حبيبته، وسيرة مخياله الأول «راشد»، فلا يملك السارد إلا أن يتماهى معه في البحث عن فتنة سيرٍ عديدة متبددة وضائعة، في الوطن، وفي القرى، وعبر المنافي البعيدة!!
في الفن تأخذ التداخلات والتعارضات مداها القصيّ، ولكنها تنضج بين يدي الكاتب الذي يعرف أدواته بحرفية عالية. وبإزاء هذا االعمل الملفت «رقص» يمكن للقارئ أن يرى إلى دلالات حضور السيري الذاتي البارزة، عبر امتزاج الروائي بالسارد، وبسيرة البطل المحرِّض على الكتابة « سعيد»، وبتفاصيل تحيل إلى العائلة، والقرية، والزوجة، والمكان بكل تفاصيله ( قرى الجنوب، الرياض، باريس)، وكذلك في إصراره على تلبّس النص ثوب السيرة الذاتية المروية أمام جماعة محددة، من خلال تكرار لازمة: « يا جماعة الخير «.
لكننا سنرى من الجهة المقابلة، أن الروائي لم يغلق الأفق على ذاته السيرية وحسب، و لكنه يتحول من كونه بؤرة محورية للسرد إلى أن يغدو « مرآة « عاكسة لكل الشخصيات، الرئيسية والثانوية، من خلال رؤية فنية متكاملة، صاغت منجزها برهافة لغوية مقتصدة اتسمت بالحكمة و التأملية والتخييل، و قامت بتشغيل فواعل سردية أخرى، انبنت على تفتيت الذرى الدرامية و توزيعها، وعلى كسر الخطية التصاعدية للزمن، حيث بدأت من أعلى قمم زمنية الكتابة.
لذلك، فإن هذا التداخل النصي بين السيري الذاتي والمتخيل السردي في هذا النص و في أمثاله، يدعوني للوقوف على النقاط التالية:
* خطاب السيرة الذاتية، غالباً، ما ينزع إلى الكشف عن تفاصيل حياة الشخصية الكاتبة، في تعالقاتها وتجاذباتها وصراعها مع الآخر، على ما يراه حقيقة واقعية، يعمل على تجلية تفاصيلها واستهدافاتها وشخوصها المشاركين في ذلك السياق. ويستعين في هذا المجال بأدوات وثائقية تعضّد مصداقية الخطاب و فعالية مقوله ( تواريخ، وثائق، وأمكنة و أحداث معروفة)، حيث لا يحفل السارد كثيراً بإبراز حضور وحيوية الشخصيات الأخرى، ليكون الكاتب هو السارد وهو البطل، حتى وإن تخفّى خلف إسمٍ مستعار، أو ضمير سرد للغائب.
أما خطاب المتخيل السردي، فإنه عادةً، ما ينشئ حياة موازية للواقع، وتعارضاته، مستنداً على الفاعلية الجمالية للنص، و المنفتحة على الأزمنة والأحداث و تعدد الشخصيات، لإيصال رسالته الجمالية والدلالية للمتلقي.
* إذا أخذنا بالرؤية الإيجابية لبعض النقاد والقراء المهتمين بالسرد، و الذين يميلون إلى اعتبارالاتكاء على السيرة الذاتية في إنتاج الرواية دلالة على عجز الكاتب عن مواصلة مسيرته الروائية، مثلما قيل عن غازي القصيبي و تركي الحمد وأحمد أبو دهمان، فإنني على ثقة بأن كاتب رواية « رقص»، بكل ما أبدعه من متخيل سردي، قادرٌ على إبداع الكثير من الروايات المتميزة.
* سأميل دائماً إلى «العنونة « التي يختارها الكاتب ويدوّنها على غلاف عمله، لتمييز جنسه، أكان سيرة ذاتية، أم «رواية»، وبعد ذلك علينا الاحتكام إلى شروط الإبداع، وحدها، دون الذهاب إلى التجسس على المكونات الأساسية للنص، سواءً جاءت من مصدرها السيري الذاتي أم من متخيلها السردي، لأن القارئ المستمتع بفنية النص لن يكون منحصراً في فئة قليلة قريبة من تفاصيل حياة الروائي وتجاربه المعاشة، ولنا في رواية « تلك الرائحة» لصنع الله إبراهيم، خير أنموذج لقدرة المبدع الموهوب، على إحالة سيرته الذاتية، إلى عمل روائي متميز، ما فتيء النقاد يقاربون جماليات تشكيله، منذ ستينيات القرن الماضي و حتى اليوم!
* في خضم هذا الجدال حول التعالق النصي بين السيرة الذاتية والرواية، حسم كثير من النقاد مواقفهم حين أسموها « رواية السيرة الذاتية». وأنا سأتفق معهم في ذلك، شريطة توفرها على متطلبات إبداع النوع الروائي، مثلما استوفته « رقص».
وسيرى القارئ في هذا النتاج، أن الكاتب قد امتلك فاعلية «التحويل» ليعمل بمهارة فنية عالية على رفع مستوى السيرة الذاتية و حرارة التجربة اليومية، وصدقها، إلى فضاء المتخيل السردي، حيث عمد إلى تظفيرها في أبعاد اسطورية وملحمية، و واقعية و تأملية. وقد أسهم هذا التخليق - « التحويل» الفني في تعميق آليات استقبالها لدى القارئ، بما تستثيره في وجدانه من جماليات التشوف والحنين إلى المستقبل، وبما انطوت عليه – أيضاً - من حمولات شجن الأسى الوجودي للإنسان، الذي ما زال كل يوم يرفع صخرة «سيزيف» إلى الأعلى، ثم يهوي معها!