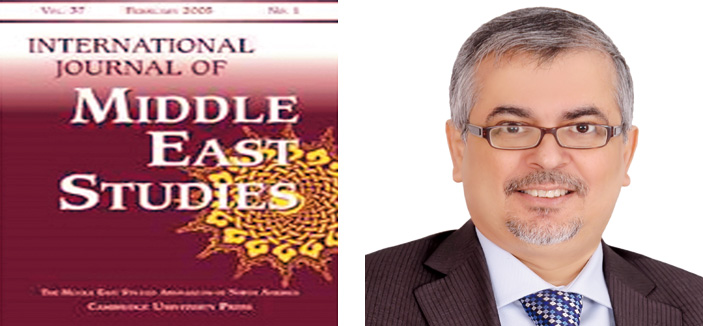قراءة غير تبجيلية...
الشريعة في السودان: التطبيق والنتائج (3-4)
لقد قام هو وأتباعه بإعادة بناء الحركة في مخيمات اللاجئين في ليبيا حيث شنت الجبهة الوطنية بزعامة الأنصار، ثورتها الأكثر جرأة ضد النميري في يوليو عام 1976. نجاة النميري كانت - جزئياً على الأقل - مسؤولة عن المصالحة الوطنية التي بدأت بعد عام واحد بالضبط. ومن المرجح أن النميري والصادق أدركا أنه يتعذر هزيمة بعضهما البعض بسهولة، ولذلك قررا التصالح. اعتقد كلا الخصمين أنه يستطيع تحييد خصمه لاحقاً من خلال المناورات السياسية، ولكن بعد عامين أصبح واضحاً للأنصار أن المصالحة لن تتحقق. عندما أعلن النميري المسار الإسلامي في سبتمبر 1983، لم يتردد الصادق في وصف تلك السياسة بأنها (غير إسلامية). وفي خطبة في مسجد الأنصار في أم درمان، قال: (قطع يد السارق في مجتمع يقوم على الاستبداد والتمييز هو مثل رمي رجل في الماء، ويداه مكبلتان، وأمره بأن لا يبتل)(14).
وبعد خلع النميري، أصبح الصادق أكثر جرأة. لقد حلل خمس مبادرات قانونية رئيسة لنظام النميري الإسلامي، ليبرهن لأتباعه أنها تشكل إفساداً كلياً لجوهر الإسلام. كما شجب جميع الأحكام القانونية التي تم إصدارها على أساس ما يسمى بـ (قوانين الشريعة) باعتبارها (غير إسلامية) تماماً في روحها وفي أسلوب تنفيذها. وبخلاف رفضه الكامل للطريقة التي تم عبرها تطبيق الحدود، فقد خص أعنف النقد - تحديداً - لاقتصاد النميري الإسلامي، موضحاً أنه لم يلتزم بالفهم الحقيقي للإسلام. لقد دعم الصادق إنشاء دولة إسلامية بشرط أن تقوم على تطبيق كامل ومثالي للشورى في جميع القضايا السياسية وأن تقوم على العدالة الاجتماعية في سياستها الاقتصادية. وشدد الصادق على أن تنفيذ الشريعة الإسلامية في العصر الحديث يجب أن يقوم على أساس (اجتهاد معاصر) وينبغي أن يأخذ في الاعتبار الظروف الحالية ويستمد حكمه من القرآن والسنة.
الإسلام وجنوب السودان
واحدة من أخطر تداعيات مرحلة النميري الإسلامية، كانت تجدد الأعمال العدائية في الجنوب في عام 1983؛ فحتى ذلك الحين كان اتفاق أديس أبابا في 27 فبراير 1972، يعتبر بحق أهم إنجاز، إن لم يكن الإنجاز الوحيد لنظام النميري. لقد وضع نهاية لـ 17 عاماً من الفتنة العدائية الداخلية، ومنح الاعتراف بشجاعة للطابع التعددي للمجتمع السوداني.
وبمنح الجنوب الحكم الذاتي الإقليمي، اعترف النظام الذي يهيمن عليه المسلمون أن الثقافة والعرق والدين، والاقتصاد توجب إتباع منهج جديد يناسب التركيبة الداخلية السودانية. وكان هذا، في الواقع، جزءاً من خطة لإبطال النظام المركزي السوداني وتحويله إلى نظام (لا مركزي)، وبخاصة في مجال التنمية الاقتصادية، التي كانت قد أعلنت من قبل نظام النميري منذ عام 1971. وكان حجم السودان، والفروق الهائلة بين مناطقه، وتركيز السلطة الاقتصادية والسياسية في أيدي نخبة شمالية لا تمثل الشعب السوداني كافة، قد أثار انتقادات قوية لتلك المعاملة التفضيلية الممنوحة لشمال السودان ليس على حساب الجنوب فحسب، ولكن أيضاً على حساب دارفور وكردفان في الغرب وقبائل البجا التي تسكن تلال البحر الأحمر في الشرق(15).
كان اتفاق أديس أبابا ينص على المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين. واعترف الاتفاق بالهوية الثقافية الجنوبية، وبالتالي، أعلن عن حقها في التشريع بحسب عاداتها وتقاليدها والديانات السائدة من مسيحية ووثنية. صدر مرسوم الانتخابات الحرة لتأسيس الجمعية الإقليمية للجنوب ومكن هذه الجمعية من انتخاب رئيسها الخاص. الأساس الأبدي (غير قابل للتغيير) لهذا الفكرة عُبر عنها في الدستور الدائم للسودان الصادر في مايو 1973. المادتان رقما 6 و7 حددتا مبادئ (اللامركزية) ووعدتا بأن تفاصيل هذا النظام الجديد ستصدر عن الحكومة في المستقبل القريب. وأسست المادة الرقم 8 الحكم الذاتي الإقليمي في الجنوب على أساس دائم لا يمكن تعديله إلا بما يتوافق مع بنود قانون الحكم الذاتي لعام 1972. وما لا يقل أهمية عما سبق، هو البند الذي نص بأن غير المسلمين سيتم حكمهم بالقوانين الشخصية الخاصة بهم. وتم تأكيد تعددية المجتمع السوداني، بما في ذلك تكوينه المتعدد الأديان، في المادة الرقم 16، التي وعدت بالمعاملة المتساوية لجميع أتباع (الديانات والمعتقدات الروحية)، وانتهى البند بالقول إن (إساءة استخدام الدين... لأغراض سياسية محرم)(16). وإذا أخذ المرء في الاعتبار الحقائق السائدة في السودان والتطرف الراديكالي الإسلاموي في البلدان المجاورة، بما فيها مصر، فلا يمكن أن يعتبر دستور عام 1973 خطوة متطرفة نحو التشدد الديني.
ولكن كان الساسة الجنوبيون، إلى حد كبير، معارضين للدستور لأنه ينص على أن (القانون والعرف الإسلامي هما مصادر رئيسة للتشريع) (المادة الرقم 9)، وأن العربية ستكون (اللغة الرسمية) للسودان. أحد أكثر المعارضين جرأة كان بونا ملوال، وهو وزير سابق للثقافة والإعلام في نظام النميري، والذي عبر عن مخاوفه في وقت مبكر من عام 1977 عقب اتفاق المصالحة. ووفقاً لملوال، فإن الترابي كان يعتبر أن إضعاف الجنوب خطوة أساسية ورئيسة نحو تنفيذ الشريعة. لو كانت هناك عدالة في السودان - يقول ملوال - فلم يكن ينبغي أن يطرد الترابي من منصب النائب العام فحسب، ولكن كان يجب أن يتهم (بالتآمر للإطاحة بنظام الدولة الشرعي) لأنه كان يدعو علناً إلى انقلاب إسلامي. ولكن القادة الجنوبيين كان لديهم ثقة قليلة في طائفة الأنصار. تجربتهم مع حكومات طائفة الأنصار/حزب الأمة في الستينيات علمتهم أن القيادة الطائفية التقليدية ليست أفضل من أتباعها المعاصرين. وفي الواقع، ووفقاً لملوال، فقد ذكر الصادق في وقت مبكر، عام 1966، أن (فشل الإسلام في جنوب السودان سيعتبر فشلاً للمسلمين السودانيين في تعزيز قضية الإسلام عالمياً. الإسلام لديه مهمة مقدسة في أفريقيا وجنوب السودان هو بداية هذه المهمة)(17).
بدأت فترة التعايش السلمي بين الشمال والجنوب تتعثر بعد اكتشاف النفط في الجنوب وقرار النميري غير الدستوري بحل الجمعية الإقليمية للجنوب وحكومتها في فبراير 1980.
وأعقب ذلك صدور قانون اللا مركزية، الذي كان يهدف لتقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم منفصلة، وكذلك قانون حكومة الإقليم لعام 1980، الذي قسم السودان، باستثناء الجنوب، إلى خمسة أقاليم(18). هذا العمل ربما كان نتيجة الاضطرابات في دارفور ورغبة النميري بتحويل جزء من المسؤولية للحكومات الإقليمية. ولكن في الجنوب تم تفسيره على أنه اعتداء على استقلاليته وثروته المكتشفة حديثاً، والتي كان ينبغي استخدامها لصالح سكانها. وبالرغم من أن الأعمال العدائية في الجنوب سبقت - حقاً - تنفيذ القوانين الإسلامية، إلا أنه من المؤكد أن تلك القوانين فاقمت الوضع وزادت سرعة تدهوره إلى حرب أهلية واسعة النطاق تحت قيادة العقيد جون قرنق، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان.
التداعيات:من الديمقراطية
إلى الاستبداد العسكري
في أعقاب خلع النميري في 6 أبريل 1985، ابتهج السودانيون بصخب وبصورة غير مسبوقة بحريتهم المكتسبة حديثاً. وخلال أسبوعين بعد الانتفاضة أعلن نحو 40 حزباً سياسياً عن وجودهم، وعبروا عن نيتهم بتأدية دور فعال على الساحة السياسية. وكان من بينهم الأركان الثلاثة للجبهة الوطنية: (أ) الإخوان المسلمين، الذين غيروا اسمهم الآن إلى (الجبهة القومية الإسلامية) بقيادة حسن الترابي؛ (ب) طائفة الأنصار بقيادة إمامها بالنيابة الصادق المهدي زعيم الذراع السياسي (حزب الأمة)؛ (ج) طائفة الختمية الصوفية بزعامة محمد عثمان الميرغني والذي (أصبح يرأس حالياً) (الحزب الاتحادي الديمقراطي). وكان كل منهم قد أدى دوراً مهيمناً في الفترة بين عامي 1964 و1969، وكانوا مسؤولين - إلى حد كبير - عن فشل محاولات سابقة لتأسيس ديمقراطية في السودان.
وكان النميري قد سجن الترابي في مارس بتهمة عبر عنها النميري شخصياً بقوله: (تسبب الإخوان المسلمون في جميع علل السودان). أُفرج عن الترابي في 6 أبريل 1985، وكان أول زعيم سياسي يقابل قائد الانقلاب الجنرال سوار الذهب، الرئيس المؤقت للدولة السودانية. عَبَّر الترابي عن الدعم الكامل لتنفيذ الشريعة في الماضي والمستقبل، وأشاد الترابي بالتدابير الاقتصادية مثل قانون الزكاة وما حققه من تطور للوصول إلى مجتمع عادل. انتقاده الوحيد كان بخصوص تنفيذ الشريعة فحسب، في أنها لم تكن شاملة بصورة كافية لتشمل قضايا مهمة مثل (القانون الدستوري) وبخاصة في ما يتعلق بالشورى.
قدمت الجبهة القومية الإسلامية برنامجها بشأن مسألة جنوب السودان في مايو 1985، في مؤتمر حضره نحو 100 من أنصارها في الجنوب. وذكرت أنه لا توجد أي أسباب موضوعية لتجدد الأعمال العدائية، وبالتالي، لا ينبغي أن تؤثر الفتنة الجارية على تنفيذ الشريعة. أما بالنسبة إلى المستقبل، فقد أصرت الجبهة القومية الإسلامية أولاً، على أن مسلمي الجنوب الذين عانوا لفترة طويلة ينبغي أن يتم منحهم (حصتهم الشرعية) من السلطة في المنطقة. ثانياً، أشاد مؤلفو (برنامج الجبهة) باستمرار الأسلمة السريعة للجنوب. وأخيراً، أكدت الجبهة أن (نظاماً عاماً يستند إلى الشريعة الإسلامية هو ضرورة دينية وسياسية لكل مسلم). وذلك لأن الشريعة هي أقرب من أي نظام قانوني آخر للتراث الثقافي الأفريقي، ونظراً إلى أنها (تحمي وجود كيان الدولة وثقافة غير المسلمين)، فإنه يجب المحافظة عليها باعتبارها قانون السودان الذي يتمتع (بمرونة تضمن التسويات المطلوبة من قبل غير المسلمين)(19).
وأيد هذه الآراء الترابي وزملاؤه طوال المرحلة الديمقراطية الثالثة في السودان عندما عارضوا باستمرار أي تغيير حقيقي في القوانين الإسلامية وتنفيذها. واعتبر الترابي أن الاحتجاجات ضد الشريعة تأتي بوحي من الغرب الذي سعى إلى فصل السودان عن أشقائه العرب والمسلمين. وأكد أن طلب قرنق إلغاء القوانين لا علاقة له بالدين، بل لأن حركته تقوم على المبادئ الماركسية. وفي رأي الترابي، كانت الدولة الإسلامية في السودان حقيقة واقعة وتعتمد على دعم شعبي، ولذلك، فإن أولئك المعارضين للشريعة هم عملاء للغرب وينبغي رفع راية الجهاد ضدهم. وعندما انضمت الجبهة القومية الإسلامية لحكومة ائتلافية في مايو 1988، وشكلت مع حزب الأمة، حكومة (الوفاق الوطني)، فإنه كان من الواضح أنه لن يكون هناك تنازلات بشأن الإسلام، حتى لو كان هذا يعني استمرار الحرب الأهلية (20).
أصبح محمد عثمان الميرغني، زعيماً للطريقة الصوفية الختمية في عام 1968، بعد وفاة والده، سيد علي الميرغني. وكانت الختمية تتجنب تقليدياً المشاركة الفعالة في الحياة السياسية واستمرت في هذا الخط تحت قيادة النميري. وكرئيس لمجلس النهضة الإسلامية الصوفية، الذي تأسس في عام 1978، قدم الميرغني دعمه لما يسمى بـ سياسة النميري الإسلامية، ووصف منافسيه (الأنصار) والإخوان المسلمين بـ (المسلمين المتغربين)، ولكن بعد سقوط النميري، شجب الميرغني (أسلوب) تنفيذ الشريعة لأنه كاذب ومضلل وظالم، ويستند إلى قانون الغاب. ولكنه عَبَّرَ عن قناعته بأنه تحت التوجيه الديني والروحي السليم من علماء وفقهاء مؤهلين يمكن تدارك وإصلاح العيوب.