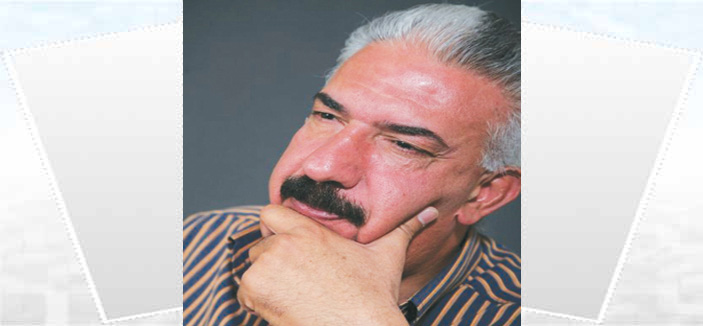لَعِب على الحافة
لا أعرف على وجه الدّقّة ما الذي يحدث معي، خاصّةً حين أشاهد تلك الفتاة المريبة التي تظهر لي فجأة هنا وهناك، والتي تبدو بهيئتها المتحوّلة في كلّ مرّة وكأنّها تمارس معي تمارين خاصّة بالتّخفّي. عندما ألتقيها تتقدّم منّي بخطى مرتبكة، تنظر إليّ باستغراب، وتقول: « يا شاعري ألا تعرفني؟ أنا ريم «. كان ذِكْر ذلك الاسم أمامي يصيبني بمشاعر متناقضة من الحب والغضب، الرّقة والقسوة. ولكنّ المشكلة هي أنّني أصطدم في كلّ مرّة بريم جديدة، ريم لا علاقة لها بريم السابقة. وهكذا أجدني أمدّ يدي ببلاهة لأسلّم عليها، أبتسم لها بدبلوماسية، وأقول: « آه... أهلاً ريم، ما هي أخبارك ؟». تلك العبارة المبهمة التي أتلفّظ بها ليست في واقع الأمر سوى محاولة للإفلات من الشَّرَك الذي أجد نفسي فيه عندما أقابل تلك الفتاة. أحاول أن أعصر ذاكرتي باستمرار علّي أربط بين الاسم وصاحبته فلا أستطيع.
ثمّة فُتات ذاكرة، أو على الأصح فُتات لصورة غائمة اسمها ريم، تُطِل علَيّ بين الحين والآخر بهيئات مختلفة عن هيئتها السابقة. لقد صرت مقتنعاً أنّ تلك الفتاة ما هي إلاّ مجرّد اختراع شاركت أنا فيه بشكل من الأشكال. فأنا غالباً ما أنهمك بأحلام اليقظة التي تختلط بأحداث الواقع وتصبح جزءاً منها. وبسبب هذا الاختلاط فأنا لا أستطيع أن أميّز بين ما هو حلمي وما هو واقعي في الحياة.
منذ عشرين عاماً تعرّفت إلى ريم. أوّل مرّة شاهدتها فيها كانت في منتدى ثقافي. كنت قد دعيت إلى إقامة أمسية شعرية في ذلك المنتدى، وما إن انتهيت من قراءة القصائد حتى تقدّمت مني فتاة في العقد الثالث من عمرها. كانت تبدو سمراء وناحلة أكثر مما ينبغي، وكان أكثر ما يميّز ملامحها هلالان أسودان عريضان يحرسان عينيها النّاعستين. شعرها هو الآخر كان أسود فاحماً عقدته في ضفيرة واحدة طويلة، ورمته إلى الوراء. مثل مصلّية هندية تحتفي ببوذاها وقفت أمامي، وهمست بشغف قديم: « أنا ريم «. كنت كمن أصابه مسّ، فصوتها لم يكن أيّ صوت، لقد اندلع في أعماقي كالنّار، وصار يعوي في وديانها مثل ذئب هائج. قالت لي وكأنّها تصدر تقريراً نهائيّاً بشأن تجربتي الشعرية: « الجانب اللذّي في قصائدك كبير، هذا شيء جميل، ولكن حاول أن تخفّف منه لصالح مقاربة الكارثة «. أيّة كارثة؟ تساءلت بيني وبين نفسي، ولكنني فيما بعد أخذت أميل إلى البحث عن عنصر آخر كان مفقوداً في شعري، وهذا العنصر يتعلّق تحديداً بمشكلة الوجود.
مرّت سنوات على ذلك اللقاء الأوّل دون أن أراها. كانت خلال ذلك الوقت تتّصل بي على الهاتف. كانت تسرد لي حكايات غاية في الخيال، بعضها يتّصل بي، وبعضها يتّصل بأناس أعرفهم. كنت أستغرب كيف أدخلُ هذه الأجواء الفانتازيّة لفتاة لا أكاد أعرف عنها شيئاً يُذكَر. وفي إحدى المرّات تحدّثت لي عن ولهها العظيم بالسّواد! قالت إنّها اشترت حمامةً صغيرةً سوداء ووضعتها في قفص داخل غرفة نومها. « قطعة الليل تلك لكم هي مدهشة «، تقول « إنّها تقرّبني من عتمة نفسي، وتجعلني أكثر قدرة على تلمّس الوجود الرّخو ومعرفة معنى العدم «. في أحد الأيام حدّثتني عن رغبتها العارمة في الانتحار! لقد صعدَتْ إحدى البنايات العملاقة قالت، ولكنّها حين أطلّت على المدينة من علٍ اكتشفَتْ قماءة الأشياء، وتفاهة أن يضيف جسدها الضئيل صفراً آخر للأصفار الكثيرة التي تنتشر أسفل منها، ممّا حملها على التّراجع مؤقّتاً عن الفكرة. « لا بدّ أن يكون لي سقوط مدوٍّ « قالت، « سقوط يكون له وقع كوكب عظيم على الأرض «. أنا من جانبي رحت أضخّ فيها الأمل، وأشجّعها على الخروج من المأزق الذي هي فيه، قلت لها: « أنت مجنونة كبيرة، هل جرّبت الحبّ في يوم من الأيّام «؟ ردّت بصوت كلّه حزن: « لقد جرّبته معك أيّها الشاعر»!
الآن وبسبب الحزن حزنها الذي أتذكّره، أذكر في مرّات عديدة رسائل الحب التي كانت تبعث بها إليّ قبل الإنترنت وقبل الإيميلات. كانت تلك الرسائل تطفح بالأشواق العارمة، ولكنها كانت أشبه بمحاضرات صغيرة في الفلسفة والفنّ. وكنت أتساءل بيني وبين نفسي عن السّرّ الكامن وراء هذه الطاقة الغريبة التي يكتنزها رأس فتاتي الأحمق. في أحد ردودي على رسائلها تحدّثت لها عن الأثر العميق الذي يتركه كلامها فيّ، كما وصفت لها طريقتي الخاصة في الاحتفال برسائلها، لقد ذكرت لها أنّني أقوم بتمزيقها قطعاً صغيرة حتى لتبدو مثل فُتات الحليب، ثمّ إنني أرشّها بعد ذلك على جذوع الأزهار في البيت، فلربّما تحيلها إلى قصائد بدل الرائحة! مثل هذا التصرف من قبلي كان كافياً لأن تقول لي في إحدى رسائلها « هذا يكفي لقد جنّنتني، سوف آتي إليك وأفترسك يا حَمْلي الوديع «.
وبالفعل فقد جاءت مرّات عديدة، ولكنّها كانت في كلّ مرّة تظهر فيها على مسرح الأحداث تفاجئني بطراز جديد ومختلف عمّا كانت عليه في الماضي. أنا في هذه الكتابة الشبيهة بالاعترافات لا أتحدّث عن التغيّرات التي تطال الزّيّ أو المكياج عادةً، بل إنّني أتحدّث عن تلك التّغيّرات الحقيقية التي تطال الملامح، السّن، الطّول، ولون البشرة أيضاً. أذكر في أحد المساءات، وكنت قد ذهبت لحضور حفل افتتاح معرض تشكيلي أنّ امرأة في مثل سنّي تتقدّم مني بخطوات خجولة، وأنّها حين صارت أمامي وجهاً لوجه رفعت عينيها وابتسمت لي تلك الابتسامة السّرية المدهشة المهرطقة التي تبعث في جسدي الجنون، والتي سبق لي أن شاهدتها مرات عديدة على شفاه ريماتي الكثيرات. قالت: « أنا ريم، هل يمكن أن تكون قد نسيتني «؟ تفرّست في ملامحها وهتفت في أعماقي: « يا إلهي عفوك، ما الذي حدث «؟ كانت ريم هذه المرّة تبدو كنسخة مشوّهة عن نفسها. شعرها المجعّد الأشيب، عينها الكبيرة السائلة مثل حبّة خوخ مهروسة، التّجاعيد الكثيرة في عنقها، كلّ ذلك صنع منها بابولينا عظيمة، بابولينا هالكة في أواخر أيّامها.
أمس شاهدتها في السينما ... كنت واقفاً بالقرب من شباك التّذاكر حين اعترضت طريقي تلك الفتاة الغريبة بفستانها الأخضر الفضفاض، وقبّعتها السوداء الصغيرة. « سوف أشتري لك تذكرة « قالت، « وسوف نحضر الفيلم سويّةً «. لم أجد ما أقوله لتلك الفتاة التي قطعت بالفعل تذكرتين، وعادت لتكمل كلامها: « يبدو أنّك مفتون بصوفي مارسو يا شاعري، ألا تجد هناك شبهاً بيني وبينها؟ بالنسبة لي أنا جئت لأرى صورتي على الشاشة، أو على الأصح لأتأمّل حياتي من خلال الفيلم «. نظرت إليها فوجدت الشّبه هائلاً بين الاثنتين، وهتفت في سرّي: « يا إلهي، أيّة أحابيل ينسج لي هذا المساء المخاتل؟ ثمّ ومَن هذه الجنية الطالعة من كتاب الأساطير «. قالت وكأنّها سمعت ما يدور في رأسي: « معقول! ألا تتذكّرني! أنا ريم، ريم يا شاعري. ريم يا طفلي الكبير «. مدّت أصابعها الصغيرة، ومسّدت فروة رأسي، ثمّ قادتني من يدي باتّجاه صالة العرض. عبرنا الباب الخشبي الكبير، ودلفنا إلى العتمة، حيث قضّينا ساعتين في مشاهدة الفيلم، كانت صوفي مارسو تبدو بكامل ألقها وهي تبتكر نفسها في نهاية الفيلم. علّقت ريم: « قدر المرأة أن تنبعث من جديد، وأن تتبع الحكيمة الأفعى».