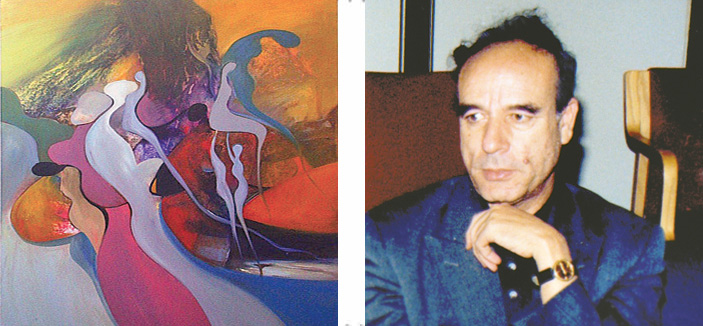وظيفة الأدب؟ (1)
من الآراء التي تروج بين الحين والآخر، في كثير من الأوساط، أن « الأدب» لا وظيفة له، فهو فاقد للفائدة يكاد لا يصلح لشيء. وإذا كان قد نهض، مثلما اعتقد كثير من النقاد القدامى والمعاصرين، يونانيين وعرب وغربيين، بوظيفتي الإفادة والإمتاع فإن ذلك النهوض، مع ما تخلله من مبالغة في تضخيمه، قد انحسر، اليوم، إلى حيّز شديد الاقتراب من الانقطاع والامّحاء. فالنفع أصبحت تنهض به قطاعات علمية ومعرفية متنوّعة والإمتاع أصبح منوطا بفنون كثيرة عتيقة ومستحدثة.
رواجُ مثل هذا الرأي، من حين إلى آخر، يلفتُ النظرَ إلى مجموعة من القضايا تتعلق بالوظائف التي ينهض بها الأدب والفن والمعرفة وأثرها في الأفراد والمجتمعات. وإذا كان الباحثون قد دأبوا على مواجهة المسألة التي تطرحها وظيفة الأدب بالإقبال على ترديد عبارات عامّة من قبيل إنه « من البيّن أن الأدب يكشف من الإنسان عن...» أو « ما من شك في أن الأدب يقوم بتهذيب الأذواق وتنمية إنسانية الإنسان..»أو» يكشف الأدب عن المعنى الذي يحمله التاريخ في عصر من العصور...»، فإن هذه العبارات، بعد ما أدركه البحث في الأدب من تطوّر وأدركته علوم إنسانية كثيرة من عظيم التهذيب، لم تعد قادرة على الإقناع. قد كان ذلك ممكنا في العهود التي كان العلماء فيها يعتقدون في الحقائق الثابتة وفي أن الأدب يشمل، بفضل اتساعه، معظم أجناس الكلام. أما اليوم وقد حقق البحثُ في الأدب والعلوم الإنسانية والمعرفة البشرية عامة تطوّره المشهود، ومع ما أصبح يأخذ به من نسبية الحقائق وموقعيتها وآنيتها، فقد بات من المؤكـّد أن وظائف الأدب، متى كانت له وظائف، تطرح كثيرا من الإشكالات المسرفة في التشعّب والتعقيد.
فالبحث في ما إذا كانت للأدب وظائف يحيلُ على البحث في « الأدب» نفسه ما إذا كانت له مقوّمات خاصّة تحوزه عمّا يشتبه به وتفرده كائنا قائما بذاته بين الظواهر والكائنات الكلامية والفنيّة حتى يكون مؤهلا للقيام بالوظائف التي لا ينهض بها سواه. وهذا قد حظي بنصيب وافر من عناية المنظـّرين في النصف الثاني من القرن الماضي حتى بلغوا فيه شأوا بعيدا من دقة الفهم في ما يُعرف بـ»الانفجار التنظيري». ثم إن البحث في ما إذا كانت للأدب وظائف يحيل، من ناحية ثانية، على البحث في ما إذا كانت للأدب «حقيقة» يحملها ويفصح عنها. وهذا قد اشتغلت عليه طوائف كثيرة من الفلاسفة والإبستيموليجيين. وفي كلا المبحثين كانت المشكلات تتضاعف وتتفرّع وتتعقد. ولعل القول بأن الأدب « لا يصلح لشيء» لا يستبعد أن يكون نتيجة من نتائج قلة التوصّل، في هذين المجالين كما في غيرهما من المجالات، إلى نتائج مقنعة رغم أن ما تمّ التوصل إليه فيهما لم يكن بالهيّن أو القليل.
كانت الأبحاث الكثيرة والمتنوّعة التي أجريت على «الأدب» ظاهرة ومصطلحا ومفهوما قد اتجهت، منذ اشتغال أصحابها به، إلى الفهم الذي يعدّه كائنا من كلام يُبلغ إبلاغ الكلام ويُفيد إفادته مضطلعا بوظيفة التخاطب والإخبار، وظلت مشدودة إليه. يدلّ على ذلك أن معظم الباحثين، نقادا وعلماء، لم يختلفوا، مثلما نرى في جلّ المدارس والاتجاهات والنزعات، في أن الأدب يحمل رسالة من الأديب إلى قرائه. كان اختلافهم منحصرا فقط في طبيعة الرسالة التي تحملها الأعمال الأدبية فرأت طائفة منهم أنها إخبار عن الأديب وعن الإنسان الكامن وراءه، ورأت طوائف أخرى أنها إخبار عن العصور التي عاش فيه الأدباء أو نفسياتهم أو الأنساق الثقافية التي ينتمون إليها. للأدب إذن، حسب هذه الاتجاهات، «حقيقة» يعبّر عنها ويحملها، وهذه الحقيقة هي التي تطلبُ من قراءته ودرسه. وعندما جاءت الحداثة حاملة معها فهما آخر للكائن الأدبي ينحو به منحى الخروج عن منظومة الأجناس الأدبية إلى « النص» عنوانا لها جامعا، ورأى الآخذون بها أن الرسالة التي يحملها الأدب لا تتعدّى الكلام الذي يَصنعُ ذاته به وأن العلاقة بينه وبين الدلالة على خارج عنه خلفٌ في خلفٍ، انحصرت إفادته في التعرّف عليه في حدود كيانه منفصلا عن العالم فهو لا يتعدّى إليه. وإذا كانت الحداثة قد شرعت في الانحسار فإن مكاسبها، وهي غير قليلة، ما زالت، مشوبة بكثير من التردد في ما يخترق « ما بعد الحداثة» من تذبذب ونكوص، تسعى إلى تجاوز الحدود التي وقفت عندها بالنفاذ إلى مفاهيم أكثر وضوحا وتماسكا. وهذا يعود، من بين ما يعود إليه، إلى أن نقد «الحداثة» لم يتمّ بعدُ على النحو الذي يؤدي، مثل النقد الذي استهدف « ما قبل الحداثة»، إلى الاستفادة من مكاسبها.
فالذي يغلب على نقد الحداثة، في قصوره عن تجاوز الانزعاج من بعض المقولات التي تأسست عليها، قد جعل معظم الجهود الرامية إلى تخطيها تكاد تقتصر على أن تنكر عليها، من بين ما تنكره، ذهاب أصحابها إلى أن « المؤلف قد مات» أو أن «حقيقة» الأعمال الأدبية مضمنة بها لا تتعدى كيانها إلى شيء آخر خارجها. أما تجاوز مثل ذلك الانزعاج وهذا الإنكار إلى رؤية أخرى تتولد عنها، مستفيدة من قوّة الحداثة ومن وَهَنها، فالعلامات الدالة عليه ما زالت غير واضحة المعالم. ولا يستبعد أن يكون الاقتصار على الانزعاج من بعض المفاهيم التي جاءت بها الحداثة دون التجرّد لنقدها النقد الذي يستخلص الإيجابيات التي أثرَت بها فهمَ الأعمال الأدبية وطوّرت التعاملَ معها قد أسهم في الذهاب، بين الحين والحين، إلى أن الأدب « لا يصلح لشيء» وأنه مجرد «لعب بالكلام» لا يفضي إلى حقيقة من الحقائق سواء في التمسك بالحقائق المطلقة أو القول بأن كل حقيقة إنما هي مرتهنة بظرفها ارتهانها بالمجال الذي تتعلق به.
يصعب، اليوم، الاستمرار في الاعتداد بأن للأدب الوظائف التي اعتقد معظم العلماء والباحثين، في مختلف الحضارات والثقافات، أنه ينهض بها، فالفائدة المعرفية والإمتاع الوجداني أمور تشترك فيها الأعمال الأدبية مع الأعمال غير الأدبية مثلما تشترك فيها مع غيرها من الفنون، والمشترك لا يعتدّ به في النفاذ إلى التفرّد والخصوصية. ثمّ إنه يصعب، من ناحية ثانية، الاقتناع بأن الأدب لا وظائف له وأنه « لا يصلح لشيء»، وإلا فما الذي جعل منه « ظاهرة كونية» لا يخلو منها مجتمع أو لا تفرد له البشرية في مختلف عهودها الحضارية منزلة، متميزة أحيانا، في منظومة اهتماماتها؟
بين أن نعدّ الأدب كلاما ينهض بما ينهض به الكلام من وظائف الإبلاغ وحمل الرسائل وأن نعدّه كلاما لا ينهض بالوظائف التي ينهض بها الكلام أو لا ينهض بها على النحو الذي ينهض هو به مجموعة كبيرة من التساؤلات يعسر، في الغالب، توفير الأجوبة عليها دون التوغل في فهم الطبيعة التي يختصّ بها الكائن الأدبي ويتميّز ويتفرّد.
هل يمكن مثلا أن نفترض أن الأدب ينطوي على «حقيقة» من الحقائق ويسعى إلى إيصال رسالة عن العالم والوجود والإنسان لها النفع الذي للحقائق العلمية؟ هل يمكن أن نفترض أنه، مثل الفنون، يمتع فيرهف الحسّ ويهذبه مفتـّقا في الإنسان مزيدا من الإنسانية ينأى به عن الحيوان الكامن فيه؟ لكن أي الحقائق ينفرد الأدب بإيصالها؟ وما الذي يجعله يوصلها على نحو مغلف بالمتعة؟ وهل المتعة التي يوفرها الأدبُ تتفق مع المُتع التي توفرها الفنون الأخرى أم تختلف عنها؟ وما الداعي إلى الاختلاف متى كان له موجب؟ أم أن في الأمر أشياء أخرى غابت عن الأسلاف دهورا أو أوهموا بها، عن طريق الحدس، دون أن يجدوا لبلورتها سبيلا حتى إذا وصلنا إلى زماننا هذا وجدنا أنفسنا بين أمرين: أن نسلم بأن الأدب لم يعد « يصلح لشيء» ، فما كان قد صلح له في غابر الأزمان لم يعد له محل من الوجود، أو أن نستمرّ في الاعتقاد بأن له في الحياة وظائف لا ندري، على وجه التحقيق والتدقيق، ما هي.