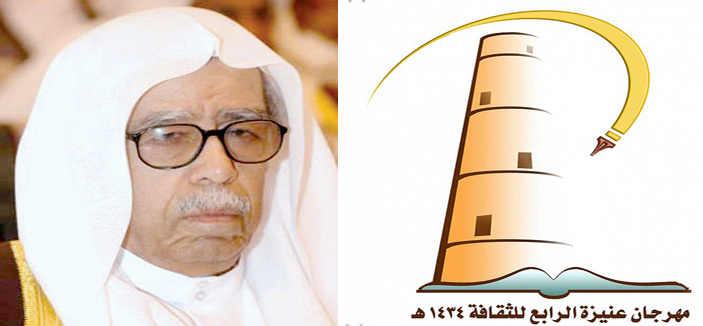مهرجان عنيزة الرابع
عناية بالرواد واهتمام بالثقافة واللغة
في زمن مليء بالصخب والضجيج والقلق، ليس من متاعب الحياة ومصاعبها فقط، وإنما مما يدور حول المرء ومحيطه من اصطراع وتناطح دموي في غالبه، يأتي مهرجان عنيزة الثقافي الرابع الذي أقامته الجمعية الخيرية الصالحية في مركز صالح بن صالح الاجتماعي خلال الفترة بين 22 – 26 ذي القعدة 1434هـ محطة استراحة للنفس والفكر بما زخر من مِتع علمية، وأدبيَّة، وثقافية. لكن أبرز ما شد انتباهي، بقوة، تلك اللمسة الرائعة من الوفاء بتكريم كوكبة من رواد المجتمع ورائداته أحبوا الوطن فأعطوه خير ما يكون العطاء في مجال الخير والثقافة والعلم.
في هذه المناسبة تستعيد ذاكرتي هجوماً شرسًا شُن في إحدى صحفنا قبل عقد من الزمن على كاتب دعا مرة لتكريم الأستاذ صالح الذكير (رحمه الله)، صاحب زاوية (الذاكرة الضوئية)، ومؤلف (رواد في الذاكرة، ونساء في الذاكرة، وعلماء في الذاكرة)، وكأنما دعا إلى منكر والعياذ بالله، فلم يبق إلا أن يعاقب عليه جزاءًا له وردعًا لأمثاله، هذا والدعوة لتكريم رجل، فكيف لو كان دعا لتكريم امرأة من الفضليات اللائي خدمن الأمة أو الوطن؟
الحديث عن مشاهد الروعة التي شاهدتها إبان هذا المهرجان كثيرة سواء في فعاليات المهرجان، أو ما تخلله من جولات وزيارات لأماكن رائعة كالمسوكف، وشخصيات أجمل وأروع. لكن مع ذلك لا يخلو الأمر من منغص، فما رأيته من ندرة الحضور من باقي مناطق المملكة يحز في النفس، ويدعو للأسف، ويقينًا لا يتحمل المسؤولية عن هذا القائمون على المهرجان، فعلى حد علمي أن شخصيات أعرف بعضها دعيت ولكنها لم تحضر، وقد يكون ذلك لعذر، والأدعى للأسف أكثر أن حضور الجمهور، أيضًا، لا يتفق مع الجهود المبذولة لإنجاح المهرجان، ولا مع الفعاليات الجميلة التي نفذت خلاله، وإذا كان ثمة من عذر لتواضع الحضور نهارًا بذريعة العمل أو الدراسة، فلا شك أن الغياب عن الفعاليات المسائية لا يمكن التماس العذر له بحال. اللهم إلا إذا عزي إلى ظاهرة العزوف عن الفن والثقافة والعلم الطاغية الآن، والاهتمام بأشياء أخرى كالتسمُّر أمام شاشة التلفاز، أو (الواتسب)، وما شابه.
إنني لأخشى أن أميل إلى الظن بأن هذا ربما يكون حصيلة مخرجات التربية والتعليم، وهو جانب يبدو أنه كان حاضرًا بقوة في الندوة التي عالجت قضية ضعف اللغة العربية، وإن كانت الإشارة إليه أقرب إلى التلميح منها إلى التوضيح.
نعم، التساهل في التعليم، وضعف التنشئة على حب العلم والثقافة هو ما أدى إلى مثل هذه الحال من التردي في مستوى الاهتمام بالنشاطات الأدبية والثقافية والعلمية، والفنية. والنتيجة الحتمية لعدم الاكتراث هذا هي الضعف العام في التحصيل المعرفي وخصوصًا اللغوي منه، برغم كل ما قيل ويقال عن الجهود المبذولة في التغيير والتطوير المستمر في المناهج التعليمية. لكن يثب في ذهن المهتم بهذا الشأن أسئلة محيرة: كيف تسنى للآباء بلوغ هذا المستوى الطيب من إتقان اللغة؟ وما وسائلهم وأدواتهم؟ رغم ما نعلمه من تواضع تلك الوسائل والأدوات والإمكانات في زمنهم؟ القلم إن وجد فهو من قصب، والورق إذا أمكن الحصول عليه فبشق الأنفس، أما الإضاءة ليلاً فالسراج، وفي الأغلب القمر، ناهيك عن التنقل وما إليه من وسائل.
أعتقد - بكل تواضع، وأنا ممن أدرك التعليم القديم في الكتاتيب، أو المطوع - أن السبب في قوة أولئك هي منهجهم التدرُّجي في تعليم الطفل، فالطفل في المنهج القديم يتعلم قراءة الحروف ثم القراءة، ثم إتقان القراءة والكتابة قبل أن يشرع في تعلم أيِّ علم من العلوم الأخرى، مع معايشة مستمرة للقراءة والكتابة، فالطالب يكتب له سطر واحد: بيت شعر أو حكمة، فيطلب منه ترديد ذلك السطر حتى يتقنه قراءة، فإذا أتقنه قراءة شرع في كتابته، ولا يعطى غيره حتى يتقنَه كتابة، وهكذا. هذه المعايشة المستمرة - في تقديري - هي أهم الأسباب في إجادة الآباء للغة.
أما ضعف التعليم الحالي فسببه - في ما أحسب - إرهاق الطالب - منذ الصغر - بموادَّ كثيرةٍ لم يحن الوقت، بعد، لكي يستفيد منها. فهو يمضي ست سنوات كاملة يتعلم فيها موادَّ كثيرةً لا يحتاجها في هذه السن، بل هو في حاجة إلى أن يتعلم كيف يقرؤها ويكتبها أولاً، بينما المنهج الحديث يلزمه بتعلمها أولاً، أي إنه يكلف بقراءة ما لا يتقن كتابته، وكتابة ما لا يحسن قراءته. أليس هذا خللاً في المنهج؟
المعضلة الأخرى تكمن في أداة المعرفة العربية نفسها وهي الكتابة. إن المتأمل في طبيعة الإملاء العربي يدرك مدى العسر والجشوبة في تعلمه، فلو أخذنا الهمزةَ مثلاً واحدًا، ودققنا في اختلاف أوضاعها، وتعدُّد صورها في الكتابة فسوف نقر حتمًا بالأثر السلبي لهذا التعدد في صور الكتابة لهذه الهمزة الشكسة، ناهيك عن باقي الحروف؛ كالحالات والصور المتعددة التي يكتب فيها حرف الألف، فهو يثبت في حال لا ينطق فيها، وينطق في حال أخرى دون أن يكون له وجود.
ثم لا ننسى الشكل، وقد أصبح تركه في الكتابة من أهم الأسباب في ضعف اللغة، الآباء كانوا يتعلمون القرآن كله، وكلُّه مشكول، وهذه معايشة أخرى للنطق السليم، والرسم السليم.
هذا في الكتابة، وأما الحديث عن اللغة فطويل وذو شجون.
جهود التحديث والتطوير مستمرة في المناهج، فماذا لو جربنا - ولو لفترة وجيزة - الاقتصار في السنة الدراسية الأولى على ثلاث مواد رئيسة هي القراءة والكتابة والحساب، والتركيز عليها حتى يحسن الطفل القراءة والكتابة السليمة؟ ثم نبدأ في إدخال المواد تدرجيًّا حسب أهميتها، مع مراعاة تهيئة الطالب لما يحتاج إليه من مواد الدين حسبما يناسب سنه.
ماذا لو أجريت هذه التجربة في سياق العديد من التجارب الكثيرة التي مرت بها عمليات التطوير والتغيير في المسيرة التعليمية؟