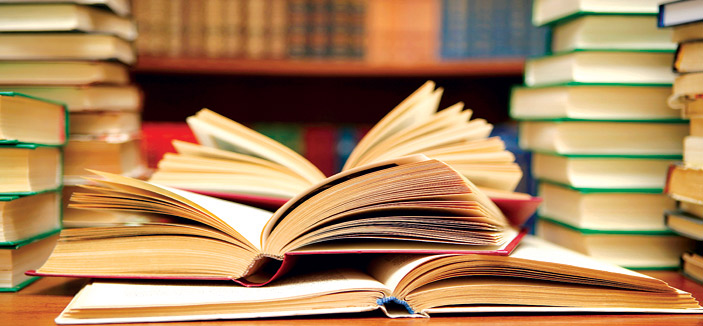في وداع.... مكتبة!!
(ممّا حدّثت به بيبلونة ردّ الله غربتها)
في لحظةٍ إشراقٍ ما -ليست لحظةً صوفيةً ولا فلسفيةً- تجلّت لي مكتبتي هناك، أو ما كان اسمها مكتبةً فقد قسمها قصف الطيران إلى قسمين منفصلين، أظنها صارت أشبه بخزائن المطبخِ حشرت فيها الكتبُ صدفةً! تصلني صورها وأظل عاجزةً عن أن أفعل لها شيئًا أو حتى أواسيها.
لا تعيش كتبي هنا، في منفاي القسري كما قال لي أحدهم، حياةَ كتبٍ طبيعيةٍ - نعم للكتب حياةٌ طبيعيةٌ تمامًا مثل البشر- لأنها بلا أرفف تتكّئ عليها، محبوسةٌ في صناديقَ ثلاثة تحت طاولةٍ ما، لا ترى الضوء ولا يراها، مثلي حين أنعزل عن العالم، أو على الأقل كما أتمنى أن أفعل في لحظات الصمت الكبرى....
إن كنت تعلّمتُ شيئًا من النمل فلا شك أنني تعلمتُ الادخار والتخزين، النمل الذي يغتنم الفرصَ كلما رأى فتاتًا جاء مهرولًا ليحملَ مؤونته التي تجعله يستلقي طوالَ الشتاءِ، تصورتُ النملاتِ مستلقياتٍ باسترخاءٍ قرب موقد النارِ، تقرأ إحداهن قصيدةً بصوتٍ عالٍ بينما تنهمك أخرى في حياكةِ جواربِ الصوف وهي تضع نظارة كبيرةً ولفافاتٍ في شعرها تمنحها تسريحةً قديمةَ الطراز وتعلو وجهها ابتسامةٌ مطمئنةٌ تمامًا مثل الجداتِ في قصص الأطفال المصورة!
قيل لي كثيرًا إن الغرباءَ لا يؤسسون مكتبةً، لكني لم أستطع التخلي عن طبعي «النملي» في التخزين! غير أن علي الاعتراف أني اقتنعت -مؤخرًا- مرغمةً، لم أعد أقتني الكتبَ «التي في خاطري وفي دمي» وأحاول التخفيفَ مما أملك أساسًا، لذا وجدتُ بعض الراحة من «عذابات بروميثوس» التي أقاسيها حين أعلنتْ إحدى الجمعيات الخيرية عن استقبالها لما يفيض عن الحاجةِ من المطبوعات، وتخففتُ من شعوري بالحرج كلما حاولتُ التخلصَ من كتابٍ سيئ الطباعةِ أو يصل مجانًا مع إحدى المطبوعات، هكذا على الأقل سيعاد تدويرها - على ذمةِ الجمعية- وأكون قد أديتُ خدمةً جليلةً للكتب الرديئةِ وللبيئةِ وللإنسانية، وأفسحتُ المكانَ لكتبي التي أحب كي تتنفس!
صارلديّ الآن ثلاثُ مكتباتٍ في ثلاثة بلدانٍ مختلفةٍ، وفي كل مرةٍ أحمل أنا حقيبة سفري ببساطةٍ تاركةً إياها، بالرغم من عادتي بحملِ مجموعةٍ معي أينما سافرتُ مما يضطرني للمفاضلةِ بينها، أليس هذا فعلٌ خائنٌ بحدِ ذاته؟ تراها تحبني كتبي أم توهمْتُ ذلك؟ ربما تود التخلصَ مني لكنها لا تجد إلى ذلك سبيلا!
كلما كان الحديث عن الكتبِ أعرف أنني أضيعُ خيوطَ الفكرة، هل للفكرة خيوطٌ؟ لعلها تشبه ذاك الجوربَ الذي تحيكه تلك النملة!